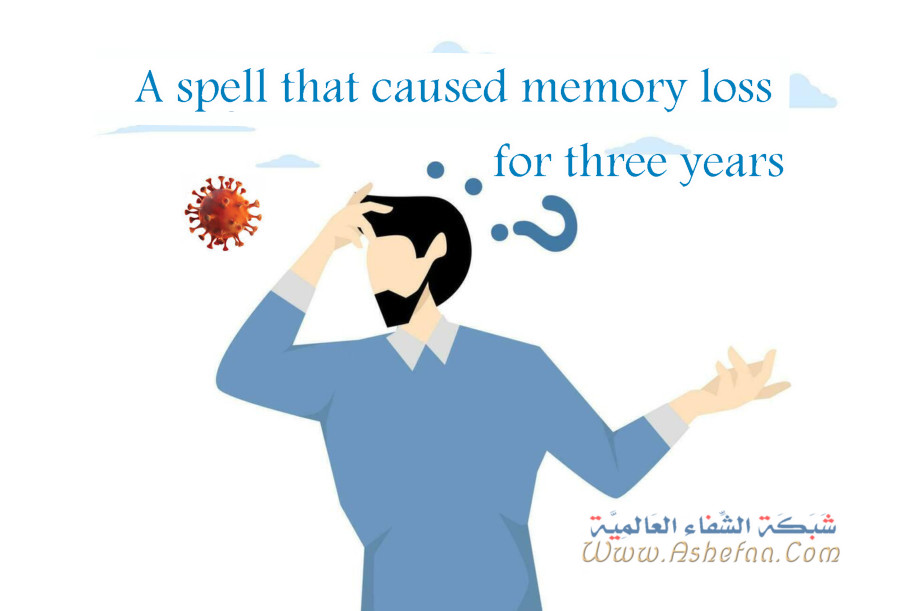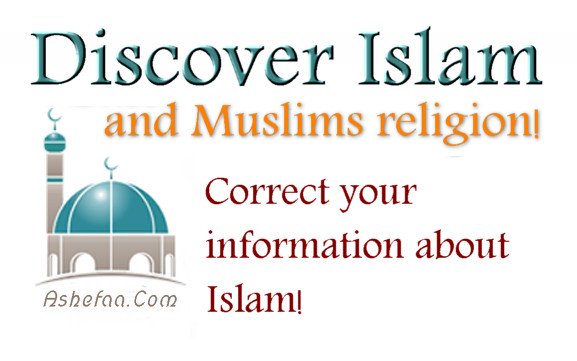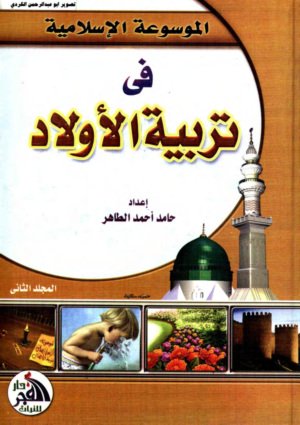طروحات الإسلاميين نضوج التجربة والاستعداد للسلطة:
النموذج التركي والإشارات من بلدان "الربيع العربي" و"الأخوان" اللبنانيون (2/2)
فادي شامية- اللواء-الثلاثاء,20 كانون الأول 2011 الموافق 25 محرم 1433 هـ
في الأول من شهر كانون الأول الجاري اختصر رئيس حكومة قطر؛ الشيخ حمد بن جاسم، المشهد القادم في العالم العربي، عندما قال في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز": "إن الإسلاميين سيمثلون -على الأرجح- الموجة التالية من القوى السياسية في العالم العربي، وإن على الغرب التعاون معهم".
نصيحة حمد بن جاسم للغرب –كما تبدو- تقوم على أساسين:
أولاً: فشل سياسة اجتثاث أو تحجيم الإسلاميين لصالح أنظمة وثيقة الصلة بالغرب.
ثانياً: تطور طروحات الإسلاميين أنفسهم، بعيداً عن الصورة النمطية التي روّجها خصومهم عنهم، وأسهمت أخطاؤهم بوضعهم فيها.
الانفتاح على الإسلاميين
واقع الحال؛ أن الغرب أصبح مستعداً فعلياً للتعاطي بإيجابية مع الحركة الإسلامية، لا سيما طليعتها؛ "الأخوان المسلمون"، التي ينتشر رموزها -من مختلف الأقطار- في الخارج، والتي بات الحوار معها معروفاً... ومنتجاً أيضاً. وينطلق الانفتاح الغربي على الإسلاميين، من وجود نماذج مشجعة، بما في ذلك إشارات إيجابية في البلدان التي شهدت ثورات تحررية مؤخراً.
وتأتي التجربة التركية في طليعة التجارب التي يراها الغرب مشجعة جداً، وهذه التجربة نفسها تشكل اليوم إلهاماً للحركات الإسلامية في البلدان العربية، لدرجة أن الحركات "الأخوانية" باتت تستوحي الاسم نفسه تقريباً لأذرعها السياسية ("الحرية والعدالة" في مصر و"العدالة والتنمية" في المغرب). التجربة التركية، مضافاً إليها التراكم في تجارب الإسلاميين في بلدانهم؛ جعلت طروحاتهم أكثر "نضجاً"، بما في ذلك طروحات القوى السلفية نفسها.
والواقع أن تجربة الإسلاميين الأتراك، تطورت كثيراً منذ أن ظهّرها أبو الحركة الإسلامية نجم الدين أربكان، فمع حل حزبه "الرفاه" الذي كانت طروحاته قريبة من الطروحات التقليدية لـ "الأخوان المسلمين"؛ انتقل أربكان إلى طروحات أكثر "قبولاً" في حزبه الجديد؛ "السلامة"، ثم جاءت النقلة النوعية مع تلميذه رجب طيب أردوغان الذي أنشأ حزب "العدالة والتنمية"، حيث فاز في ثلاثة انتخابات متتالية منذ العام 2002، وبات رافعة تركيا الحديثة؛ اقتصادياً (أصبحت تركيا ضمن مجموعة العشرين الأولى في العالم)، واجتماعياً (تضاعف الدخل الفردي أربع مرات)، وسياسياً (داخلياً على صعيد استيعاب الأقليات والتعامل مع العسكر والقضايا الخلافية، وخارجياً على صعيد الدور الإقليمي)، فضلاً عن المواءمة بين الإسلامية والقومية واحترام الحريات... باختصار بات "العدالة والتنمية"، ذو "الخلفية الإسلامية"، صورةَ الحداثة والنمو في تركيا اليوم، وليس صورة التخلف والرجعية، على ما كان يُصوّر خصومه!.
إشارات مشجعة في بلدان "الربيع العربي"
بالانتقال إلى بلدان "الربيع العربي"، فإن الإشارات المرصودة هناك ليست سيئة-بل مبشرة-، وفي كل الأحوال فإن المطلوب من المتخوفين الانتظار والحكم على الوقائع، فقد تكون تخوفاتهم في مكانها، وقد لا تكون، والأجدى حالياً رصد المسار، والبناء على ذلك.
ولعل أول ما ينبغي أن يتوقف المراقبون عنده؛ "تطور" إيمان الإسلاميين –بغالبيتهم الساحقة- بالسلمية التي طبعت الحقبة الأخيرة من تاريخهم، رغم ما تعرضوا له من قمع، بحيث أسهموا فعلياً –هم وليس الأنظمة- في خنق الحركات العنفية التي قامت في بلداننا العربية. وفي هذا المجال لا يجوز الاستهانة أبداً بـ"المراجعات" الفكرية، التي أقدمت عليها حركات تتسم طروحاتها بالعنف، إذ نقلت "مراجعات" هذه الجماعات -في مصر وليبيا- الطروحات الفكرية من دائرة التطرف إلى رحاب الاعتدال، بحيث بات الخطاب الشرعي والسياسي لـ "الجماعة الإسلامية المصرية" -مثلاً -أقرب إلى الطروحات التقليدية لـ "الأخوان المسلمين"، بل يتعداها أحياناً في التمسك بالسلمية، و"الموازنة بين المصالح"، وبحيث حوّلت "المراجعات"، واحداً من قادة "الجماعة الليبية المقاتلة" إلى قائدٍ للثوار في معركة تحرير طرابلس من حكم القذافي (عبد الحكيم بلحاج، الذي اعتقلته القوات الأمريكية في ماليزيا عام 2004 وسلمته إلى ليبيا، ثم أجرى عام 2009 وزملاؤه "دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس" التي أثنى عليها العلامة يوسف القرضاوي والشيخ سلمان العودة وآخرون).
نجاح الحركة الإسلامية في اختبار "السلمية" ليس كلمة قالها الإسلاميون فقط، وإنما هو واقع شهدت عليه أعوام القمع الرهيب؛ في تونس (30.000 معتقل، بمن فيهم رئيس الحكومة اليوم حمادي الجبالي الذي قضى في سجون بن علي 15 عاماً من عمره، بينها 10 أعوام في الحبس الانفرادي!)، وفي مصر (اعتقال غالبية أعضاء مكتب إرشاد "الأخوان المسلمين" و40.000 ألفاً آخرين في حكم مبارك)، وفي ليبيا (حل جماعة "الأخوان المسلمين" ومحاكمة 73 من أعضائها والحكم بالإعدام على المراقب العام ونائبه عام 2002).
وسمة أخرى ميّزت أداء الإسلاميين مؤخراً؛ هي الانفتاح على القوى السياسية الأخرى. تبدّى هذا الأمر أثناء الثورات العربية (لاحظ مثلاً: "اللقاء المشترك" الذي يضم "التجمع اليمني للإصلاح" وأحزاباً قومية ويسارية وبعثية وطائفية)، فضلاً عن مرحلة ما بعد الثورة (تقاسم السلطة في تونس مثلاً).
أما فيما خص الحريات العامة وحقوق المرأة وما شابه، فإن ما أعلنه ومارسه الإسلاميون -في تونس على سبيل المثال- شكّل سابقة تستحق التأمل، حيث حصلت "النهضة" على 42 من أصل النساء الـ 49 اللواتي انتخبن في المجلس التأسيسي (بينهن غير محجبات)!، ثم جاءت تصريحات المفكر الإسلامي راشد الغنوشي فيما خص الحريات (ولبس البكيني وما شابه)، والتي استندت إلى "فقه الموازنات"، لتجعل المشهد صادماً بالفعل!.
على أي حال؛ ليس قليلاً أبداً أن يصبح التيار السلفي، الذي دأب على مقاطعة الانتخابات، وتحريمها كآلية ديمقراطية، (ليس قليلاً) أن يشكل حزباً ينافس الآخرين في الانتخابات، ثم يبدي رئيسه عماد عبد الغفور (حزب النور) استعداده للتحالف "مع أية قوة وطنية، بما في ذلك نجيب ساويرس (الذي سبق وحذر من صعود الإسلاميين)، لبناء الوطن"!. وليس قليلاً أيضاً أن يتجاوز "الأخوان المسلمون" في مصر حساسيات صراعهم المرير مع الناصريين، فيرشحوا أمين اسكندر، القبطي الناصري على قوائمهم الانتخابية. كما ليس هيناً أبداً أن تنال توكل كرمان عضو مجلس الشورى في "التجمع اليمني للإصلاح" (أخوان مسلمون)؛ جائزة نوبل للسلام، وترشح لأن تكون شخصية العام عربياً!.
التخويف من البديل في سوريا
على خلاف بلدان "الربيع العربي" الأخرى؛ فإن التخويف من الإسلاميين في سوريا يهدف إلى إحباط الثورة نفسها، وليس إحباط صعود الإسلاميين كنتيجة من نتائجها، علماً أنه لا يُتوقع أن يكون حجم التيار الإسلامي في سوريا بالحجم الذي يطرحه الذين يخيفون العالم والأقليات من "الأخوان المسلمين".
وبغض النظر عن هذه الحيثية، فإن أدبيات "الأخوان" السوريين، لا سيما في عهد بشار الأسد، لا تختلف في جانبها السياسي عن أي حزب "ديمقراطي" آخر، يتبدى ذلك في إصدارهم ما سُمي: ميثاق شرف للعمل السياسي، الذي أعلنوا فيه نبذ العنف بكل أشكاله وتأييد مبدأ الدولة المدنية، ثم إصدار برنامجهم السياسي الذي يعد قفزة نوعية على مستوى خطاب الجماعة وأدائها.
في مشروعها السياسي تتحدث الجماعة اليوم عن الدولة الحديثة، التي هي دولة تعاقدية، "ينبثق العقد فيها عن إرادة واعية حرة بين الحاكم والمحكوم"، كما تتحدث عن الدولة باعتبارها "دولة مواطنة، تقوم فيها العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس المواطنة، لا الدين. وهي دولة تمثيلية، ومؤسسية، وقانونية، تقوم على المؤسسة من قاعدة الهرم إلى قمته، وتقوم على الفصل بين السلطات، وتأكيد استقلاليتها، فلا مجال في الدولة الحديثة لهيمنة فرد أو سلطة أو حزب، على مرافق الدولة أو ابتلاعها". كما اعتبرت الجماعة أن الدولة الحديثة، هي دولة تداولية، و"تكون صناديق الاقتراع الحر والنزيه أساساً لتداول السلطة بين أبناء الوطن أجمعين". وهي دولة تعددية، "تتباين فيها الرؤى، وتتعدد الاجتهادات، وتختلف المواقف، وتقوم فيها قوى المعارضة السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، بدور المراقب والمسدد حتى لا تنجرف الدولة إلى دائرة الاستبداد أو مستنقع الفساد".
كما التزمت الجماعة في ميثاقها بآليات العمل السياسي الديمقراطي ووسائله، مؤكدة الحق المتكافئ للجميع، في الاستفادة من إمكانات الدولة، وبنبذ العنف من وسائلها، وترى في الحلول الأمنية لمشكلات الدولة والمجتمع وفي عنف السلطة التنفيذية مدخلاً من مداخل الفساد. وفي المشروع السياسي للجماعة رؤية لسوريا المستقبل يقوم على العمل أن تصبح سوريا "بلداً تسود فيها كلمة الحق والعدل... ذا هوية عربية إسلامية... تتحقق فيه الوحدة الوطنية، وينبذ التعصب الطائفي، وتتعايش فيها مختلف الديانات والمذاهب والأعراق، ضمن إطار المصلحة العليا للوطن... وينتهي فيه الصراع بين التيارات الإسلامية والقومية، ويتنافس فيه الجميع لما فيه مصلحة الوطن، النساء فيه شقائق الرجال، متساوون في الكرامة الإنسانية، ومتكاملون في الوظائف والواجبات". كما ينص المشروع على "الحق في الممارسة السياسية وتشكيل الأحزاب في إطار دستور البلاد"!.
... و"الأخوان" اللبنانيون
وأخيراً؛ فإن النموذج اللبناني لمدرسة "الأخوان المسلمين"، أي "الجماعة الإسلامية" في لبنان، حاضر بيننا، كنموذج لحزب سياسي بعيد عن العنف، يعمل وفق الآليات الديمقراطية، يدخل البرلمان ويخرج منه بلا ضجيج، ويتواصل مع الطوائف والأحزاب، ويتحالف مع بعضها، ويتحاور مع الآخرين... ويمتنع عن الانسياق في مشروع تهديم الدولة رغم مغريات مثل هذا التحالف، سياسياً ومادياً!.
المواطن اللبناني قد يحب هذا اللون من القوى السياسية، وقد يرفضه، لكن ليس من الإنصاف القول إن هذا النموذج يشكل خطراً على الديمقراطية أو الأقليات كما يروج البعض اليوم عن الإسلاميين، لا سيما في سوريا، بل إن وجود قوى إسلامية، ذات خطاب معتدل، من شأنه منع ظهور قوى أخرى ذات خطاب متطرف.
إن ما سبق كله، هو دعوة للتبصر في ملاقاة الصعود الإسلامي في منتصف الطريق، والتعامل معه كجزء من النسيج الوطني، وتشجيعه على الانخراط في الآليات الديمقراطية، ومنافسته ومعارضته حيث يجب، لما لذلك من مصلحة كبيرة لمستقبل هذا الشرق، عندما ترتاح مجتمعاتنا من ثنائية؛ إما التطرف وإما القمع، التي تكاد تقضي على الحياة السياسية، وتعطل إمكانيات التنمية والتقدم.