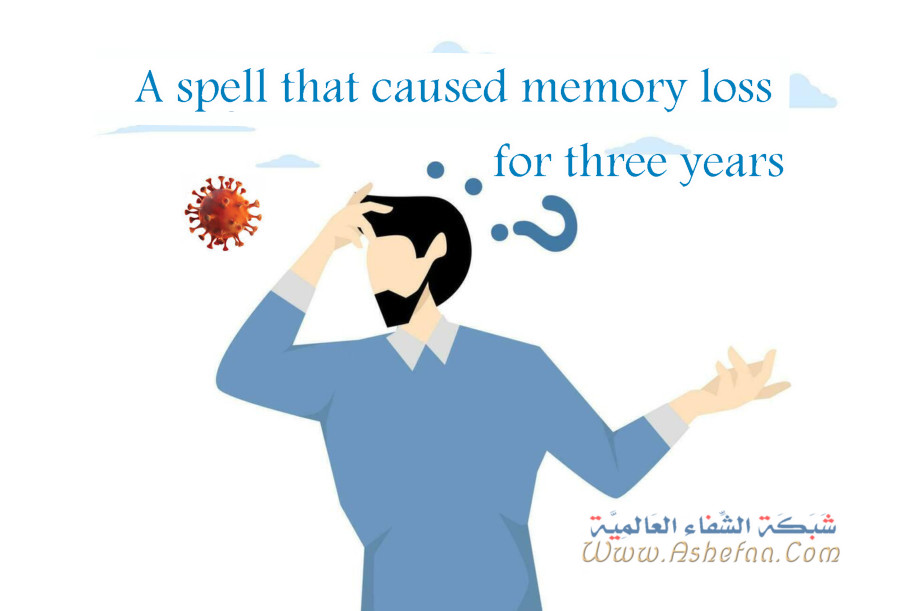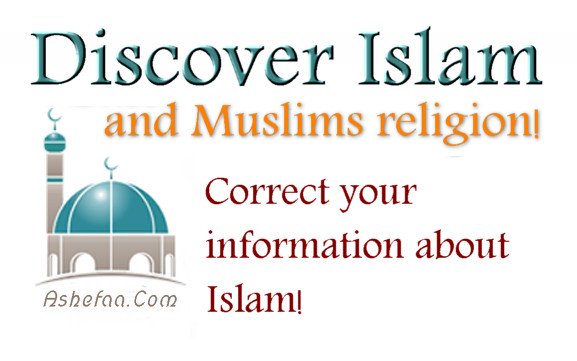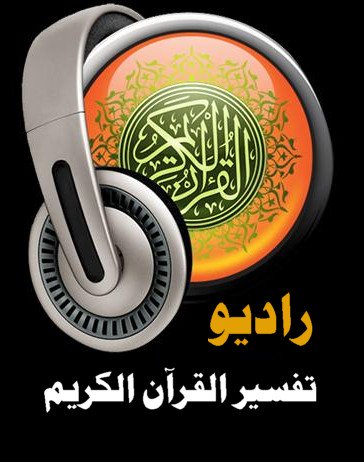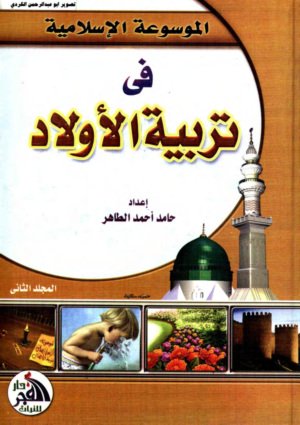بعد ارتفاع الرايات الإسلامية في مواسم "الربيع العربي":
صعود الإسلاميين؛ تحدٍ لهم ولخصومهم! (1/2)
فادي شامية
لم يكن حضور الإسلاميين في المجتمعات العربية معطى سياسياً مستجداً، فمنذ استقلال الدول العربية المختلفة؛ ثمة حضور قوي للإسلاميين في مجتمعاتنا العربية، غير أن الأنظمة التي قامت في عالمنا العربي دأبت على وصف الإسلاميين بالرجعية، وتالياً قمعهم. كما قام تفاهم غير مكتوب فيما بعد بين طائفة من حكامنا والغرب، على أساس أن الأنظمة القائمة يمكنها أن تقمع ما أسمته "الإسلام السياسي"، مقابل أن يسكت الغرب عن فساد النظام وانتهاكه لحقوق الإنسان.
ساد هذا الواقع فترة غير قليلة من الزمن، لكنه ولّد فساداً وقمعاً غير محتمل، طاول الإسلاميين وغيرهم، دون أن يتمكن من اجتثاث أو إضعاف الحركة الإسلامية، فضلاً عن تسببه بظهور "الإسلام المتطرف"، بدلاً من "الإسلام السياسي"، وهذا التطرف تطور –بدوره- من استهداف "العدو القريب" إلى استهداف "العدو البعيد" (الذي يدعم الأنظمة القائمة)، بحيث صار الإرهاب عالمياً، وكانت ذروة ذلك في أحدث 11 أيلول قبل عشر سنوات تقريباً.
إذاً؛ فإن حصيلة "عصر تغييب الإسلاميين"، أدت إلى تعيُّب الديمقراطية نفسها، وإلى استشراء الغلو الديني، وشيوع الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، فضلاً عن أن الهدف نفسه لم يتحقق، لأن جحيم القمع من جهة السلطة عَنَى جنة العطف الشعبي لجهة المعارضين، ما جعل القوة التنظيمية والمؤسسية والشعبية تتنامى لدى الإسلاميين، لتكون البديل الجاهز عند سقوط السلطة القمعية، التي بات رحيلها مطلباً لغير الإسلاميين أكثر من الإسلاميين، بعد أن طال القمع والفساد الجميع.
هذا التوصيف هو الذي يشرح؛ لماذا انفجرت "الثورة العربية الكبرى"، والأهم؛ لماذا كان الإسلاميون هم البديل عن الأنظمة المتهاوية، ولماذا بات الغرب أكثر استعداداً لتقبل حقيقة المعطى السياسي الإسلامي كما هو.
اللافت أن الرؤساء العرب الساقطين في ميادين الثورة، كانوا يدركون -أو أنهم أدركوا- هذه الحقيقة، فاعترفت ألسنتهم بما يدينهم، عندما حذروا –جميعُهُم-؛ زين العابدين بن علي، وحسني مبارك، ومعمر القذافي، وعلي عبد الله صالح، وبشار الأسد، أن البديل سيكون الإسلاميين، في اعتراف ضمني منهم بأنهم يمنعون الشعب من التعبير عن نفسه!.
تظهير وليس ظهور
وإذا كان المعطى الإسلامي السياسي غير مستجد؛ فهذا يعني أن الحديث عن ظهور الإسلاميين في مواسم "الربيع العربي" ليس في محله تماماً، والأدق القول إن الثورات العربية ظهّرت قوة الإسلاميين، الموجودة أصلاً، بغض النظر عن مدى إسهامهم في الثورات، أو استفادتهم شعبياً منها. وهذا "التصويب" يصبح متيناً جداً، إذا ما نظرنا إلى حجم الضغوط التي منعت تعبير الإسلاميين عن أنفسهم، في أزمنة الأنظمة التي أسقطتها الثورة.
في تونس- أول بلدان "الثورة العربية الكبرى"- انتقل حزب "النهضة" (أخوان مسلمون) من نسبة تمثيل هي صفر%، إلى نسبة تمثيل تعادل 42% لهذا الحزب وحده، وهذا يدل بداهةً إلى أن الحزب كان حاضراً –بغض النظر عن النسبة- في وجدان التونسيين، ولكن القمع الرهيب أقصاه، (سجَنَ نظام الرئيس بن علي ثلاثين ألفاً من أنصار "النهضة" خلال فترة حكمه).
أما في مصر –مهد الحركة الإسلامية- فقد منع نظام الرئيس حسني مبارك "الأخوان المسلمين" من المشاركة السياسية، عن طريق حزب سياسي لهم، ومع ذلك كانوا الأغلبية الشعبية خلال الانتخابات السابقة، لولا التزوير المفضوح، لذا كان متوقعاً أن يشكلوا نحو 40% وحدهم في أول انتخابات حرة (والعدد مرشح للارتفاع في الجولتين اللاحقتين)، فضلاً عن تنامي القوة السلفية إلى جانبهم، والتي سجلت نحو 20% أيضاً، فيما اندثرت تقريباً الأحزاب المصرية التاريخية كحزب الوفد (نال 6% من أصوات الجولة الأولى) والأحزاب الناصرية والاشتراكية (نالت 1% لكل منها تقريباً).
بالانتقال إلى ليبيا فإن الواقع نفسه يتكرر؛ فقد شكّلت المطالبة بمعرفة مصير الإسلاميين وغيرهم من ضحايا مجزرة سجن بو سليم عام 1996 شرارة الثورة، وما إن بدأت الاحتجاجات على نظام الرئيس معمر القذافي، حتى برز دور الإسلاميين؛ "الأخوان المسلمين"، و"السلفيين"، و"جماعة الدعوة والتبليغ"، وغيرهم، كما لعب العلماء القريبون من "الأخوان المسلمين"، أو المنضوون في إطار "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي يرأسه العلامة يوسف القرضاوي، دوراً كبيراً في تثبيت الناس وتوجيه الثورة، وبعد الانتصار على القذافي أعلن "الأخوان المسلمون" في ليبيا إعادة إحياء التنظيم، وانتخبوا بشير الكبتي مراقباً عاماً، وتتوقع المصادر المتابعة اليوم أن يفوز الإسلاميون؛ من مختلف التيارات، بغالبية مقاعد أي برلمان قادم بسهولة شديدة.
أما اليمن؛ فيعتبر حالة مختلفة، لأن الحركة الإسلامية هناك لم تتعرض للقمع العنيف، نظراً إلى طبيعة المجتمع القبلية، لكن نظام الرئيس علي عبد الله صالح، لم يسمح بتظهير "التجمع اليمني للإصلاح" (أخوان مسلمون) لقوته المتنامية، وتمسك بالسلطة في بلد شاع فيه التخلف، فكان من الطبيعي أن يكون "الأخوان المسلمون" القوة الأبرز في وجهه، الأمر الذي أجبره في النهاية على التوقيع في الرياض في 23/11/2011، على اتفاق نقل السلطة، وبناءً على هذا الاتفاق، أصبح محمد باسندوة رئيساً للحكومة الجديدة. والأخير قريب جداً من القيادي في "التجمع اليمني للإصلاح" حميد الأحمر، والأحمر أحد أهم المرشحين لرئاسة اليمن اليوم، ما يعني أيضاً أن اليمن -ما بعد صالح- سيكون تحت نفوذ الإسلاميين، في رئاسة البلاد والحكومة، وفي البرلمان أيضاً.
بدورها سوريا، مرشحة أيضاً لدخول نادي الدول التي يتمتع الإسلاميون فيها بنصيب وازن من الحضور السياسي، حيث يشكّل الإسلاميون اليوم جزءاً – يصعب قياسه- من الحراك الشعبي، وقد سبق أن شكّل "الأخوان المسلمون" الرافعة للمجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل غالبية المعارضة السورية اليوم، حيث شغل "الأخوان" 5 من أصل 29 من مقاعد هيئته العليا، إضافة إلى عدد من المستقلين الإسلاميين القريبين منهم، مع الإشارة إلى أن "الأخوان" في سوريا شكلوا طليعة معارضة نظام الأسد (الأب)، اعتباراً من العام 1979، وقد قدموا آلاف المعتقلين والقتلى خلال صراعهم المرير، وهذا ما يفسر قول الرئيس بشار الأسد (30/10/2011) "نحن نقاتل الأخوان المسلمين منذ خمسينيات القرن الماضي وما زلنا نقاتلهم".
على أن ظهور الإسلاميين لا يقتصر على البلدان التي شهدت ثورات، ففي كل بلد عربي يشهد إصلاحات؛ النتيجة نفسها: فوز الإسلاميين، (المغرب مثلاً؛ حيث فاز حزب "العدالة والتنمية"، أحد تنظيمات "الأخوان المسلمين"، في الانتخابات بـ 80 مقعداً، وأصبح رئيس الحزب عبد الإله بن كيران رئيساً للحكومة الجديدة) فضلاً عن أنهم –الإسلاميون- موجودون في كل البلدان العربية الأخرى، بلا استثناء.
التحدي المشترك
تظهير قوة الإسلاميين (السُنة على وجه التحديد) يفرض تحدياً مشتركاً عليهم، وعلى خصومهم، ذلك أن ممارسة التيارات الإسلامية الحكم شيء، وانتقاد الأنظمة السابقة ورفع " شعار الإسلام هو الحل" شيء آخر تماماً، وقريباً سيكتشف الإسلاميون قبل غيرهم مصاعب أن يكونوا في سدة الحكم، بالمقارنة مع موقعهم كضحايا سياسيين في السابق!.
ومن جهة أخرى، فإن إدارة شؤون الناس، والتعامل مع الأعراق والأجناس والأفكار والأحزاب المختلفة في البلدان العربية هو بحد ذاته تحدٍ كبير، لا سيما أن الفارق دقيق بين عرض الإسلاميين لعقيدتهم الدينية والسياسية، وبين فرض الإسلاميين ما يدينون به على الناس، بما يعني ضمان الحريات والتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة.
ومن جهة ثالثة؛ فإن الإسلاميين أنفسهم ليسوا فصيلاً واحداً –كما هي حال الأحزاب الإيديولوجية الأخرى أيضاً-، ما يعني أن التنوع الفكري فيما بينهم ينبغي أن لا يتحول إلى تنازع يُغرق المجتمعات في صراعات مستخرجة من بطون التاريخ، فضلاً عن أن لوثة السلطة لدى الإسلاميين من شأنها أن تدمر "النصاعة" التي تحظى بها صورتهم –حتى الآن- فيما خص الفساد في السلطة.
وبالمقابل؛ فإن تحديات خصوم الإسلاميين راهناً ليست أقل من تحديات الإسلاميين أنفسهم، سيما أن بعض ردود الأفعال على صعودهم تنم عن فشل في الرؤية كبير، ومخاطرة باستقرار وأمن المجتمعات العربية، لأن المناداة بالديمقراطية لا يمكن أن يكون صائباً عندما ينتج أحزاباً وتيارات معينة، ويكون غير ذلك عندما ينتج إسلاميين!، والقول بذلك يعني اضطرار الإسلاميين إلى انتهاج طرق غير "ديمقراطية" في الوصول إلى السلطة، ما يدخلنا في دوامة أكثر قتامة من الأنظمة القمعية التي كانت قائمة.
الأمر نفسه، ينسحب على الأقليات –ولكن بخطورة أكبر-، ذلك التخويف المستمر من التيار الإسلامي سوف يحمّل المحرضين عليه، مخاطر أي انتكاسة في المسارات الديمقراطية في البلدان العربية، مع العلم أن ثمة فرصة كبيرة لتكون الأقليات بكامل حقوقها في ظل أنظمة ما بعد الثورة، لأن وجود أقليات مرتاحة من مصلحة القوى الإسلامية الصاعدة، أكثر مما هو في مصلحة الأقليات نفسها!.
بقي أن من حق الإسلاميين أن يأخذوا فرصتهم، وطالما أنهم انخرطوا في آليات التداول السلمي، على السلطة، فإن إمكانية صعودهم -كما تراجعهم- أمر ممكن الحدوث، وفي كلا الحالين فإن التعامل "الديمقراطي" مع هذه التيارات أفضل للجميع... والناس هي التي تجدد الوكالة الشعبية أو تحجبها.