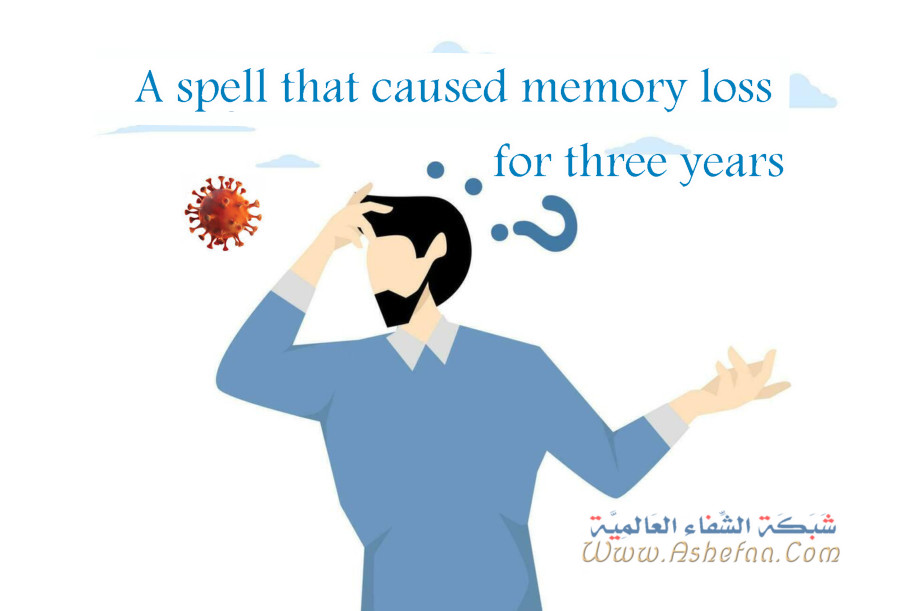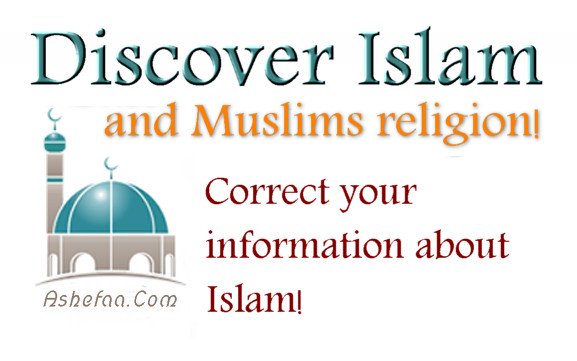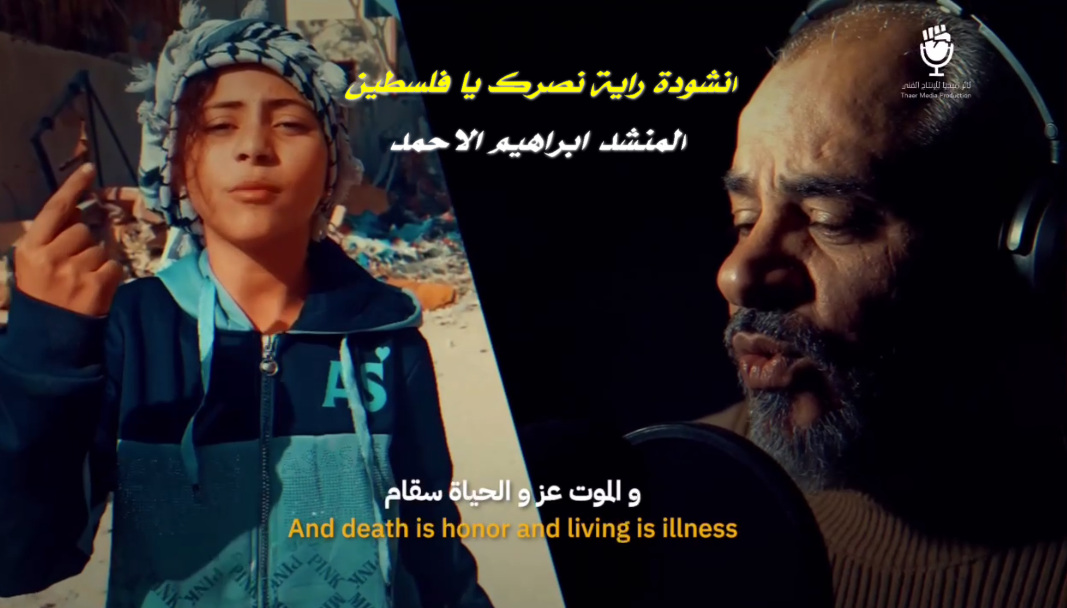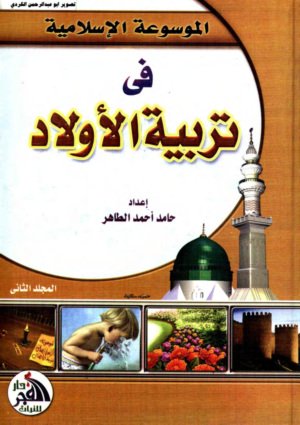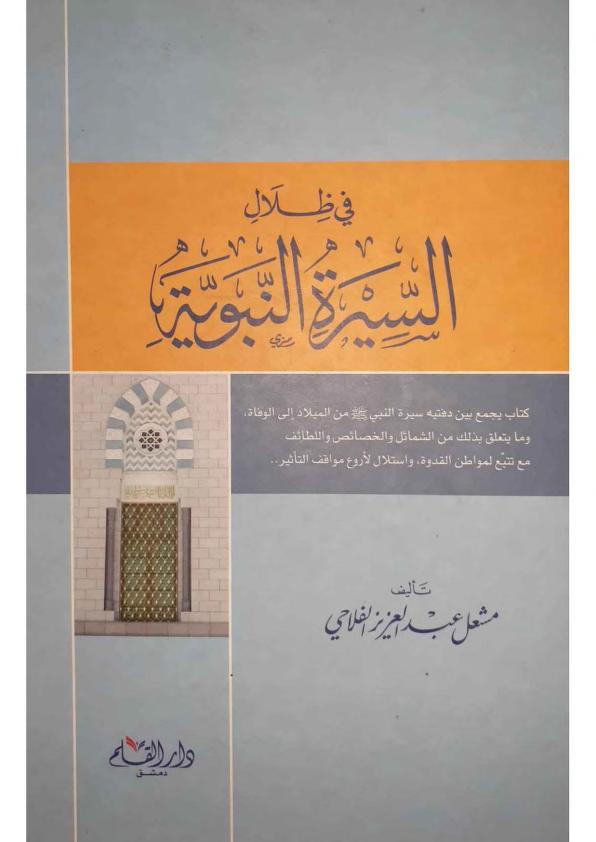هكذا قُيّد موقف الأزهر من الصلح مع "إسرائيل":
هل ستحرر "الثورة المصرية" الأزهر الشريف من قبضة النظام الأمني؟
فادي شامية- شبكة الشفاء- الجمعة18 شباط 2011 الموافق 15 ربيع الأول 1432 هـ
أدت حرب العام 1973، وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338، والنتائج غير المثمرة للمحادثات العربية- "الإسرائيلية"، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توقف "محادثات السلام"، واليأس الأميركي من إمكان تحقيق اختراق في جدار الأزمة، إلا إذا قامت محادثات ثنائية بين كل دولة عربية على حدة وبين "إسرائيل". ومع الوقت بدأ الجانب المصري يقتنع بذلك، وقد لاقى الجانب "الإسرائيلي" هذا الأمر بالترحيب، على اعتبار أن إجراء مفاوضات مع دولة عربية كبرى واحدة أفضل من المفاوضات مع مجموعة من الدول، وأن أي اتفاق سيكون في مصلحة "إسرائيل"، لأنه يفتت المجموعة العربية، خصوصاً إذا تم الاتفاق مع دولة كبرى كمصر.
فكّر السادات بولوج هذا السبيل، ولو اقتضى ذلك زيارة "الكنيست الإسرائيلي"، وقد شجعه الملك المغربي الحسن الثاني، الذي رتّب للقاء سري بين مصر و"إسرائيل" في الرباط، التقى فيه موشي ديان وزير الخارجية "الإسرائيلي"، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء المصري. بعد هذا اللقاء استقرت فكرة الذهاب للقدس في نفس السادات. وفي افتتاح دورة مجلس الشعب المصري عام 1977، أعلن السادات استعداده للذهاب إلى القدس وزيارة "الكنيست الإسرائيلي". اعتقد الجميع في البداية أن السادات يزايد إعلامياً، ليحرج "إسرائيل"، لكنه في 20/10/1977 ذهب بالفعل إلى "الكنيست الإسرائيلي"، وألقى خطاباً حول "السلام الشامل"، مستخدماً بعض العبارات العاطفية، التي لا تصلح للتأثير في المجتمع "الإسرائيلي"، مثل: الإشارة إلى أن إبراهيم هو جدّ العرب واليهود، واقتران زيارته بعيد الأضحى.
قوبلت زيارة السادات لـ "إسرائيل" بغضب عربي وإسلامي شديد، لكن المستهجن يومها أن شيخ الأزهر محمد عبد الرحمن البيصار "اجتهد" في إعطاء التبريرات الشرعية لإبعاد صفة الحرمة عن هذا الفعل غير المسبوق. اللافت أنه في الوقت الذي أفلح فيه السادات بأخذ غطاء من الأزهر لزيارته الكنيست، وتالياً توقيع اتفاقية كامب ديفيد، فقد فشل في انتزاع هذا الغطاء من البابا شنودة الثالث، الذي رفض الموافقة اتفاقية كامب ديفيد -فضلاً عن زيارة السادات للكنيست-، قبل حل القضية الفلسطينية!.
والحقيقة أنه لم يكن هذا الموقف هو الموقف الوحيد المستغرب للأزهر، فقد وافقت مشيخة الأزهر الشريف الرئيس جال عبد الناصر على كثير مما يحتاج إليه لتبرير سياساته ومواقفه أيضاً، كما جارت من بعده الرئيسين أنور السادات، وحسني مبارك. (موقف المفتي الشيخ عبد الحليم محمود من الصلح مع "إسرائيل" باعتباره حلالاً، على سبيل المثال).
وفي الواقع؛ فإن المؤسسة الدينية الأعرق في العالم الإسلامي كانت بدأت تفقد حريتها مع نهايات الملكية في مصر، ووصول الضباط الأحرار إلى السلطة عام 1952، حيث استحدث قانون يعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين شيخ الأزهر بدلاً من انتخابه من قبل هيئة كبار العلماء، وقد استمر هذا الواقع إلى يومنا هذا، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على "حياد" شيخ الأزهر في مواقفه السياسية.
وقد تجلى هذا الأمر بوضوح في المواقف السياسية على وجد التحديد، إذ لم يصدر الأزهر فتوى بتحريم اتفاقية كامب ديفيد؛ رغم إهدارها نصر حرب العام 1973، وإنقاصها السيادة المصرية، وإلزامها مصر تأمين العدو الصهيوني وسلامته وعدم تهديده من أي طرف آخر (واقع معبر رفح لاحقاً على سبيل المثال)... وأهم من ذلك كله، أن هذه الاتفاقية شكّلت الصلح الأول مع العدو، خلافاً لموقف لجنة الفتوى في الأزهر الشريف عام 1956، برئاسة الشيخ حسنين مخلوف، التي حرّمت فيه هذا الصلح بشكل واضح، إذ جاء في نص الفتوى: "... لقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل التي اغتصبت فلسطين من أهلها، وأخرجتهم من ديارهم... وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعون إليه، لا يجوز شرعًا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، وتمكين المعتدى من البقاء على دعواه... فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكّن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة، بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله، وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية من أيدي هؤلاء الغاصبين وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل، وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين".
لقد ظل موقف الأزهر في عهد ما بعد الملكية، واقعاً في قبضة النظام المصري، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا السياسية، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ فقد أصدر الشيخ الراحل محمد سيد الطنطاوي العديد من المواقف والفتاوى المستهجنة، فهو مثلاً رفض إدانة الغزو الأميركي للعراق، بل أقال أحد علماء الأزهر لإصداره فتوى بمعارضة هذا الغزو، كما أنه دعم الموقف الفرنسي في حظره ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية الحكومية في فرنسا، معتبراً أن هذا الأمر شأن داخلي فرنسي!، فضلاً عن وضعه يده – وهو ما هو من المكانة الدينية المفترضة- مع رئيس دولة العدو شمعون بيريز، وصولاً إلى فتوى غريبة أخرى تبرر إقامة الجدار العازل بين مصر وقطاع غزة بأن الجدار هو "لحماية مصر ضد أعدائها"، ثم إجباره تلميذة على خلع النقاب (بغض النظر عن الخلاف الفقهي في هذا الأمر واعتبار أكثر العلماء أن وضع النقاب رأي مرجوح)، على اعتبار أن هذا السلوك يتنافى مع موقع شيخ الأزهر المفترض.
وقد أدى مجموع هذه المواقف والفتاوى خلال عهد الراحل طنطاوي (امتد عهده 14 عاماً) وعهود من سبقه إلى زعزعة ثقة المسلمين بمصداقية الأزهـر كمرجعية دينية، ما أدى إلى انتقال هذه المرجعية إلى جماعات، ومشايخ... وربما أشباه علماء، ضلّل بعضهم الشباب ومهّد له الطريق نحو التطرف.
والسؤال الآن؛ هل ستفتح "الثورة" المصرية الشعبية الطريق أمام تحرير الأزهر من قبضة النظام الأمني، وتالياً فك الارتباط بين الموقف الشرعي للأزهر والموقف السياسي للسلطة القائمة، أياً تكن هذه السلطة؟! وهل تشكل استقالة المتحدث باسم الأزهر محمد رفاعة الطهطاوي، وانضمامه إلى "الثوار" في ميدان التحرير- قبل أيام- بداية الطريق لتحقيق هذا الأمر الذي يحفظ الدين ويعيد للأزهر ألقه؟! كثيرون يأملون بذلك.